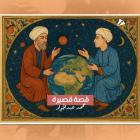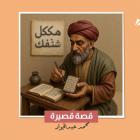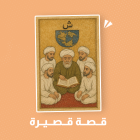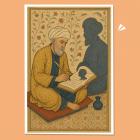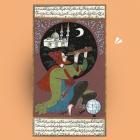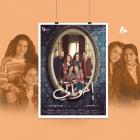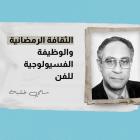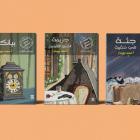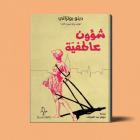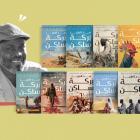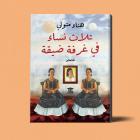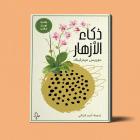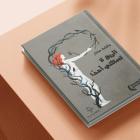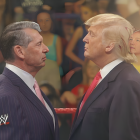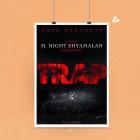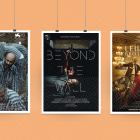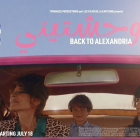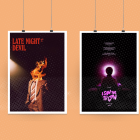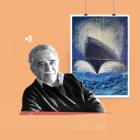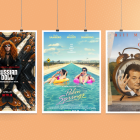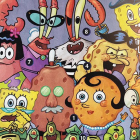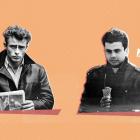فن
بين الكتابة والحياة: تورّطٌ لا فكاك منه
رحلة داخل عقل كاتبٍ يكتب ليبقى، في رواية تحفر أثرها بين خطوط الحياة والكتابة..
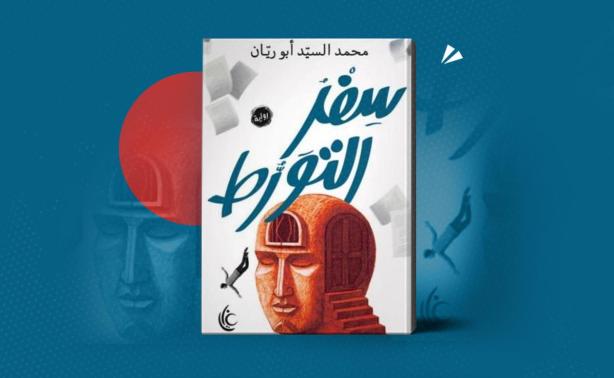 غلاف رواية «سِفر التورّط» للكاتب محمد السيد أبو ريان
غلاف رواية «سِفر التورّط» للكاتب محمد السيد أبو ريان
أحبّ الديدلاين، أعني الفكرة نفسها: وجود موعد نهائي لإنجاز هدف محدد وواضح، وأعدّ هذا أفضل محفز لي على الإطلاق. المشكلة التي نواجهها مع الكتابة أو ما يشابهها من مشاريع غير محددة الأجل، هي أننا لا نكفّ عن المماطلة، حتى لو حاولنا وضع مواعيد نحددها لأنفسنا، لا تنخدع عقولنا بهذا، وتعرف أن تلك مجرد أرقام مرنة يمكننا تطويعها أو عدم الالتزام بها مطلقًا.
في «سِفر التورّط»، يأخذ البطل معنى الديدلاين بحرفيته الإنجليزية «خطّ الموت»، فالكتابة عنده مهمة وجودية مقدسة. ليست المعادلة هنا «أنا أكتب إذًا أنا موجود»، ولكن «أنا موجود لأكتب»، فمتى توقفت عن القيام بهدفي، ينتفي معنى وجودي نفسه. لذا، يضع الخطين متوازيين أحدهما للآخر: خطّ الكتابة وخطّ الحياة، ويقرّر أنهما سيسيران جنبًا إلى جنب، وإلا سيمحوهما.
يعِدنا الكاتب من العنوان بالتورّط معه في رحلة تحمل طابعًا ملحميًّا، وينجح في تحقيق هذا من خلال المزج بين عالمي بطله، الداخلي والخارجي. وبينما تحمل مقدمات الفصول سمة الأسفار بغرابة تكويناتها ولغتها العتيقة، تأتي الفصول بلغة أكثر سلاسة وسرد جذّاب يحقّق الانغماس المقصود.
تدور القصة حول بطلنا الكاتب، الذي يعاني حبسة الكتابة، فيجرّب طرائق مختلفة للتغلّب عليها، فيبدأ ويتراجع، ويتحمّس فجأة ثم يتكاسل، وعندما يبدو أنه قد هيّأ كل الظروف المناسبة للكتابة، يأتيه خبر مرض والده الذي يهدم كل تلك الخطط.
ينقسم كل فصل من الرواية إلى ثلاثة أقسام: تجد افتتاحية قصيرة يصحبها عنوان معزوفة موسيقية، ثم هامش يطول ويقصر يدور في لاوعي البطل، وبعده يأتي المتن، أو ما يحدث في الواقع.
كانت تجربتي مع الرواية مربكة إلى حدٍّ ما، فبعض أجزائها أعجبني جدًّا، وشعرت أنها تصفني أحيانًا، وأنني مررت بمشاعر مماثلة عندما يصف نوبات الاكتئاب، أو يلعن الأرق، أو شعور الغثيان المصاحب للقلق والتوتر الذي يجعلك ترغب في تقيؤ ذاتك. أو في مشاعر الحماس الشديد عند وضع الخطط، وتقسيم الوقت، والانخراط بحيوية في عدة مشاريع دفعة واحدة. وبعضها الآخر شعرت بالانفصال التام عنه؛ فهناك مثلًا المقطوعات الموسيقية في بداية كل فصل، التي – برأيي – كانت لتصبح أفضل لو أن هناك نسخة إلكترونية من الرواية تمكّنك من الاستماع لها. وقد استطعت العثور على بعض هذه المقاطع، ومعظمها لم أستطع الوصول إليه، لذا شعرت وكأنني فقدت جزءًا من النص ذاته، فلم تكن مثالية لي.
بدت الهوامش المتعلقة باللاوعي كعوالم خوارقية شديدة الغرابة؛ تارة تذكرني بأجواء فيلم «الكثيب» (Dune)، وتارة تثير فيَّ أجواء مسلسل «رجل الرمال» (The Sandman)، الذي يحمل طابعًا ينتمي لقصص الكتب المقدسة. في البداية، تحمّست كثيرًا لهذه الهوامش، وتوقعت أنها ستسير في رحلة موازية لرحلة الكاتب الحقيقية، فتنحلّ عقدة كتابته مع عثور شخصياتها التائهة على هدف أو طريق، ولكنها مع تقادم الفصول انفكت عن هذا المعنى، ولم أتمكن من فهم صلتها بالرواية وفصولها، إذ بدت مجرد تجسيد للضياع في عالمٍ تثير تفاصيله تقززي، وقد تعمّدت أحيانًا تخطّي قراءة بعض الجمل لأثرها هذا على نفسي، وشعرت في النهاية أن عدم وجودها كان سيجعل الرواية أفضل.
لا يمكنني أن أتخطى لغة الرواية، فهي لافتة ومثيرة للاهتمام. يبدو الكاتب وكأنه يستعرض مقدرته اللغوية، وخاصة في هوامش بدايات الفصول بطابعها الغرائبي، وقد بدت لي مناسبة لهذا الموضع عمومًا. وبينما أعجبتني عدة تعبيرات نحتها الكاتب مثل «أزمتئذ»، إلا أنها في أحيان أخرى بدت متكلّفة، وكأن اللغة أهم أو أثقل من الفكرة التي تصفها.
للغة دور أساسي بلا شك في إثارة مشاعر القارئ والتأثير بها، لكني وجدتني أبتعد شعوريًّا عن المقاطع ذات التعبيرات البارزة الفخمة، إلى فقرات تبدو أبسط ولكنها أكثر شاعرية وتأثيرًا. فمثلًا، عندما يصف البطل حالته أثناء ذهابه للقاء أحد الأصدقاء، يحكي قائلًا:
«...أتشبّث بالزيف، أراهن على المجهول، أتكئ على كلّ ما أملك من اللايقين. وأعود إلى مقدمة الدوامة ذاتها من جديد».
يا لرشاقة هذه العبارة وجمالها! شعرت وأنا أقرؤها وكأنني مع البطل في السيارة نفسها التي تحمله، وبإيقاعٍ يعلو ويهبط مماثل لاهتزازاتها على الطريق. وعلى المنوال ذاته، تأتي الأجزاء التي يعود فيها البطل إلى بلدته، وتدور حول مرض والده وعلاقاته الأسرية، لتكون أكثر الأجزاء سلاسة وإمتاعًا.
تُحكى الرواية بضمير المتكلم، وعلى الرغم من أنها تغوص داخل وعي الكاتب ولاوعيه، لا أستطيع القول إنني تمكنت من فهمه تمامًا أو التعاطف معه كما يجب. تدهشني جرأته في وصف ما يحدث معه، ولكن أحيانًا أشعر وكأنه راوٍ غير موثوق (unreliable narrator)، لا يمكنني الثقة به أو تصديقه تمامًا. فمثلًا، عندما يحكي عن حلاقته المفاجئة لشعره، وكيف كرهت زوجته هذا التغيير، وقولها له: «في عينيك بريق نجس»، أشعر بعدم الثقة هنا؛ لأن الجملة أغرب من السياق الذي ذُكرت فيه، فلغتها غير متناسقة معه، فلا أدري: هل هذا قول حرفي؟ أم قرأه البطل في نظرتها؟ أم أن الموقف بأكمله قد حدث داخل عقله فقط؟
في أحيان أخرى، شعرت وكأنه يكتب عن حياته من خارجها، وكأنه هو نفسه ليس متأثرًا بها حقًّا. وقد أزعجني هذا، تحديدًا عندما يحكي عن طفولته القاسية، وتعرّضه هو وأخوه للعنف من قِبل والده، إذ يصف الوقائع ويحلل أفكاره تجاهها، لكنه لا يذكر لنا مشاعره وقت حدوثها، وكأنه مراقب حيادي لا صلة له بالأحداث سوى سردها. ولا بأس إن كان قد تخطّى أثر هذه الإساءات في الحقيقة، لكن مهمة الرواية هي أن تنقل لي مشاعر هذا الصغير، وتجعلني أحس بألمه وأتعاطف معه كأنه يمسّني.
يحمل النص توصيف «الرواية» – وأصفه به عدة مرات بالفعل – ولكنني لا أخفي شعوري أثناء قراءة بعض الفصول أنها مذكرات أو سيرة ذاتية، لسببين: أحدهما متعلق بي، وهو ألفتي بكثير من الأسماء والأحداث التي يذكرها الكاتب، مثل «فريق معرفة طنطا» الذي كنتُ إحدى أعضائه، وأذكر حضور الكاتب لإلقاء محاضرة أمامه ولقائي الموجز به يومها. والسبب الآخر يتعلق بأسلوب الكتابة نفسه، الذي كان موجزًا في مواضع تحتاج إلى التفصيل، مثلًا عندما يذكر البطل/الكاتب لقاءه بصديقين يواجهان تجربة سيئة مع أبويهما، أنتجت بدورها تصوّرات مختلفة عن رؤيتهما للإله والسلطة، فكنت أودّ أن يفسّر أكثر أفكارهما تلك ويشرحها، وإن كان يَحذر أن تُعرّض تلك الأفكار صاحبَيها للهجوم، فكان بإمكانه تغيير اسميهما أو عدم ذكرهما مطلقًا.
تورّطت مع الرواية مرتين؛ الأولى بعد أيام من حصولي عليها، وانتهت في جلسة واحدة، كنتُ أُغالِب في آخرها النوم لأنني لم أرغب أن ينطوي الليل دون إتمامها. والمرة الأخرى كانت منذ أسبوعين، حينما رافقتني في فترة انتظار مرهقة، فأنهيت أغلبها في تلك الجلسة، وأكملت الصفحات الباقية بعدها بيومين.
فاجأتني القراءة الثانية، إذ بدأتها متوجسة، أتوقّع شعوري بالملل لأنني أعيد قراءة رواية أنهيتها منذ فترة قصيرة نسبيًّا، لكن حدث العكس تمامًا. فبمجرد تخطي الفصل الأول، استعدتُ الأجواء ذاتها، كأنني أعيد مشاهدة فيلم أو مسلسل مفضّل، فكأني أنتظر ذكر وقائع بعينها، أو كلمات أعجبتني، أو مواقف أثّرت بي في القراءة الأولى.
عمومًا، لا يمكنني تقييم الرواية حسب معيار واضح، أو تخطّي إرباكها إيّاي، لكني أعلم أنها كانت تجربة جاذبة ومثيرة، قد أعود لخوضها مرات أخرى.